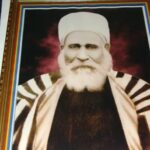بقلم الدكتور عاطف البطرس
-1-
هل هي الصدفة التي دعت إلى الحديث عن العقلانية العربية وإزدهارها في بواكير عصر النهضة ممثلة في إنتاج الدكتور طه حسين أحد أهم المنورين العرب، والداعين إلى الانفتاح الثقافي والمعرفي على الانتاج العالمي، والتحرر من المسبقات والتحيّزات والعصبيات، أياً كان شكلها وبخاصة في كتابه “في الشعر الجاهلي” الصادر عام 1926 عن دار الكتب المصرية، وهو مجموعة محاضرات ألقاها على طلابه في كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة، حيث أثار ضجة بدأت من الجامعة ولم تنته في المحكمة مروراً بما أثير حوله تحت قبة البرلمان.
الصدفة تزامنت مع رحيل أحد أبرز أعلام التيار العقلاني في تاريخ الثقافة العربية والمتابع الأمين لأهم إنجازاتها، والعامل الدؤوب على تطوير تقاليدها وإغنائها بجهوده العلمية النظرية والتطبيقية، نصر حامد أبو زيد الذي واصل جهود سابقيه من المنورين العرب، فهل طويت برحيله صفحة مشؤومة من ردود الأفعال الغاضبة والداعية إلى الإنغلاق والتكفير وهيمنة الظلامية في الفكر واغتيال حرية الرأي، أم أن المعركة مستمرة ولا يمكن لها أن تنتهي طالما أن الظلام يطارد النور، والحياة مازالت تعطي، وأشجارها دائمة الإخضرار، وفيها من شجاعة العقول، ما يكفي لرد رصاصات الغدر وطعنات الحقد بالحكمة والتعقل والكشف والاستكشاف وتقديم المعرفة العلمية والانتصار للحقيقة على ما فيها من نسبية وانزياح .
-2-
لم يمض عام على مشكلة (الإسلام وأصول الحكم) للشيخ علي عبد الرازق، حتى قامت الضجة الكبرى “وتم تهيج الرأي العام المصري، ضد محاكمة ثانية لم تختص بها هيئة كبار العلماء في الجامع الأزهر وإنما أخذ على عاتقه التحقيق فيها هذه المرة النيابة العامة مباشرة، بعد ضغوطات وحصار مرعب في البرلمان، والجامعة، والصحافة، في الوقت نفسه، معركة جديدة ضد الدكتور طه حسين، بعد إصداره كتابه في الشعر الجاهلي.
بدأت المشكلة بإشعار من الطالب الأزهري خليل حسين مؤرخ بتاريخ 30 أيار 1926 ، إلى النائب العام العمومي يتهم فيه طه حسين بأنه أصدر كتاباً يشتمل على (طعن صريح في القرآن العظيم حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي)، ثم وصل إلى النائب العام من شيخ شيوخ الأزهر، رسالة فيها تقرير باسم العلماء حول الكتاب مفاده أن طه حسين في كتابه المذكور” كذب فيه القرآن صراحةً وطعن فيه على النبي وعلى نسبه الشريف وأهاج بذلك ثائرة المتدينين، وأتى فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعو الناس للفوضى”، وأرفق البيان بصورة من تقرير العلماء.
وفي 14 أيلول عام 1926 تقدم النائب الوفدي عبد الحميد البنا ببلاغ ثالث إلى النائب العام العمومي ضد طه حسين وكتابه، (الذي طعن فيه على الدين الإسلامي وهو دين الدولة بعبارات صريحة) وأمام هذه الإدعاءات كان لابد من المحاكمة.
و19 تشرين الأول عام 1926 تولى محمد نور رئيس نيابة مصر آنذاك مهمة التحقيق مع المتهم في أربع نقاط أجمع عليها أصحاب الإدعاءات السابقة:
- أن المؤلف أهان الدين الإسلامي، بتكذيب القرآن في أخباره عن ابراهيم واسماعيل حيث ذكر في الصفحة 26، من كتابه ما نصه( للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً، ولكن ورود هذين الأسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة اسماعيل بن ابراهيم إلى مكة، ونشأة العرب المستعربة فيها، ونحن مضطرون على أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة لإثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى)،.
- أن المؤلف تعرض للقراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعاً فزعم بأنها ليست منزلة من عند الله، وإنما هذه القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوحى الله بها إلى نبيه، مع أن معظم المسلمين يعتقدون، أن كل هذه القراءات مروية عن الله تعالى على لسان النبي.
- طعن المؤلف في نسب الرسول طعناً فاحشاً حين قال في الصفحة 72، (ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه إلى قريش، فالأمر ما اقتنع الناس بأن النبي من صفوة بني هاشم، وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف، وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي، وأن يكون قصي صفوة قريش، وقريش، صفوة مضر، ومضر صفوة عدنان، وعدنان صفوة العرب، والعرب صفوة الإنسانية كلها).
- أنكر المؤلف أن للإسلام أولوية إذ يقول في الصفحة 80 من كتابه: (أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولويةً في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي، وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته، هي خلاصة الدين الحق، الذي أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل).
- وفي الصفحة 81 يقول: (وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة، أن الإسلام يجدد دين ابراهيم ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين ابراهيم هذا كان دين العرب في عصر من العصور، ثم أعرضت عنه لما أضلها به المضلون، وانصرفت إلى عبادة الأوثان)[1].
وفي الوقت نفسه كان البوليس السياسي يكتب تقريراً سرياً من نسختين إحداهما للملك والأخرى للمندوب السامي البريطاني، وذلك في 22 تشرين الأول من عام 1926، وبعدها تقرير إلى الملك في أول تشرين الثاني من العام نفسه، يبلغ الملك عن مظاهرة ستنطلق من الأزهر تنادي بسقوط الشيخ طه حسين يقودها الشيوخ ومنهم الشيخ الفقيه والشيخ محمد الاسمر، وسارت المظاهرة واشترى بعض من المتظاهرين نسخاً من جريدة السياسية “التي كان يكتب فيها طه حسين” وهتفوا وهي في أيديهم بسقوط الجريدة، ثم مزق كل منهم جريدته، وداسها بقدمه.
وهكذا انتقل الغضب على طه حسين من الأزهر والقاهرة إلى أهل المدن الأخرى في الدلتا والصعيد، من دون شك أن طه حسين المتهم، ومحمد نور المحقق فوجئ كلاهما بالمضاعفات التي تواترت في قاعة البرلمان وبين جدران الجامعة وصفحات الجرائد، حتى أصبح البحث العلمي الذي قدمه طه حسين في كتابه المذكور حديث الشارع المصري[2].
في الأدب الجاهلي
هذا كتاب السنة الماضية حذف منه فصل وأثبت مكانه فصل وأضيفت غليه فصول وغير عنوانه بعض التغيير، وأنا أرجو أن أكون وفقت في هذه الطبعة الثانية إلى حاجة الذين، يريدون أن يدرسوا الأدب العربي عامة والجاهلي خاصة من منهاج البحث وسبل التحقيق الأدبي وتاريخه.
وهو على كل حال خلاصة ما يلقى على طلاب الجامعة في السنتين الأولى والثانية في كلية الآداب.
11 أيار 1927
طه حسين
هذا حرفياً ما جاء في مقدمة كتاب في الأدب الجاهلي وبين أيدينا الطبعة التاسعة منه، وهو بدون شك أغنى وأوسع وأعم فائدة من كتاب في الشعر الجاهلي، بعد أن حذف منه الكاتب ما حذف وأضاف ما أضاف، كما جاء في مقدمته.
الحذف لا يمس جوهر الكتاب فأفكاره الرئيسة بقيت كما هي مع بعض التعديلات التي لا تعتبر تراجعاً عن أفكار المؤلف، فالمنهج واحد، والاستنتاجات العامة واحدة، وثمة تغيرات أملتها الضرورات الملحة، وهي تكتيكية على أية حال، ونحن لا ننسى أن طه حسين رجل سياسة وثقافة وفكر وأدب، وتراجع خطوة تحت وطأة الضغط العام، بهدف التقدم خطوتين، باتجاه نشر العلم والمعرفة، يبرر للكاتب ما قام به من حذف وتغيير ليضمن لأفكاره ومنهجه الشيوع والانتشار، فكان الكتاب (في الأدب الجاهلي في نسخته المعدلة).
سنحاول أن نعرض بإيجاز شديد لأهم ما جاء في الكتاب لنعيد إلى الأذهان ما يبدو أنه تقادم بفعل الزمن، علماً بأن الأسئلة الكبرى التي طرحها المنور الكبير طه حسين، ما تزال قائمة، وربما هي أكثر إلحاحاً مما كانت عليه في عصر الكاتب، أولاً لعدم استكمال الأجوبة، وثانياً لتقدم المعارف واختلاف المنسوب العلمي لإنسان اليوم قياساً بما كان عليه أيام طه حسين، ثالثاً لانكسار عصر النهضة، والتراجع عن سؤاله الأساسي، لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب، وأسئلة أخرى كحرية الفكر، وحرية التعبير، وحق التعلم، وحوار الحضارات.
ثمة اسئلة تبقى حية لا تعرف القدم الأجوبة تتغير بتغير المعارف وأدوات البحث أسئلة الدكتور طه حسين كدلالة وليس كتعيين تمتلك راهينيتها لأنها تستند إلى مفهوم /ترهين التاريخ/ كيف نقرأ الحاضر، ماذا نأخذ من الماضي، كيف نبني المستقبل، في منطق السيرورة والصيرورة، في وحدة التشكل، تلك هي اسئلة طه حسين، التي اختار موضوع الشعر الجاهلي- والأدب الجاهلي- مجالاً بحثياً لها، يتقنع بها وهو يتوخى أبعد من ذلك، يرمي إلى ما سيتابعه أحفاده من المنورين العرب، تطول قائمتهم وتتكاثر أبحاثهم وتتعمق، ينفتح الفكر، وتتنوع الاتجاهات، والمطلوب هو توحيد الإيقاع، وتلاقح الأصوات والآراء في جبهة ثقافية موحدة، أساسها التنوع، ورابطها حق الاختلاف، وقاعدتها الوحدة في التنوع، لمجابهة الأصولية الظلامية التي حاربت طه حسين، وطعنت نجيب محفوظ، وفرقت بين نصر حامد أبو زيد وزوجته، ومازالت تحارب وتكفر وتستعدي أمثالهم، ذاهبة إلى حد الاتهام بالعمالة والتخوين، علاوة على التهمة القديمة المتآكلة الزندقة والخروج عن حدود الدين.
يبدا طه حسين كتابه بعد المقدمة المكثفة بتقسيمه إلى عناوين رئيسة الكتاب الأول: الأدب وتاريخه، دروس الأدب في مصر، سبل الإصلاح، الثقافة ودرس الأدب، الأدب، الصلة بين الأدب وتاريخه، الأدب الإنشائي والأدب الوصفي، مقاييس التاريخ الأدبي: المقياس السياسي، المقياس العلمي، المقياس الأدبي، ثم متى يوجد تاريخ الآداب العربية، الحرية والأدب، وهي مقالات تلخص آراء الدكتور طه حسين، حول الموضوعات المطروحة تتسم بسعة الأفق، وعمق المعرفة، واطلاع واسع، وتملك لتجارب الآخرين، وبخاصة الآداب الأوربية لقديمة والحديثة.
الكتاب الثاني
الجاهليون لغتهم وأدبهم
تمهيد:
لعل هذا الكتاب من أهم ما جاء به طه حسين، فهو يتعلق بالمنهج وليس بالمعلومات والاستنتاجات وهو يدرك ما ينتظروه من سخط الساخطين، وازورار المزورين، لكنه مطمئن إلى بحثه، لأنه سيرضي هذه الطائفة القليلة، من المستنيرين، الذين هم في حقيقة الأمر، عدة المستقبل وقوام النهضة، وذخر الأدب، والمسألة كما يقدمها المؤلف كما يلي: (نحن بين إثنين: إما أن نقبل في الأدب وتاريخه، ما قاله القدماء، لا نتناول ذلك من النقد إلا بالمقدار اليسير الذي لا يخلو منه كل بحث، والذي يتيح لنا أن نقول: أخطأ الأصمعي أو أصاب، ووفق أبو عبيدة أو لم يوفق، واهتدى الكسائي أو ضل الطريق، واما أن نضع علم المتقدمين كله موضع البحث، لقد أنسيت فلست أريد أقول البحث وإنما أريد أن أقول: الشك، أريد أن لا نقبل شيئاً مما قاله القدماء في الأدب وتاريخه، إلا بعد بحث وتثبت، إن لم ينتهيا إلى اليقين، فقد ينتهيان إلى الرجحان) صفحة 62.
ثم يوضح الدكتور الفرق بين المذهبين في البحث، (فهو الفرق بين الإيمان الذي يبعث على الإطمئنان والرضى، والشك الذي يبعث على القلق والاضطراب، وينتهي في كثير من الأحيان إلى الإنكار والجحود، المذهب الأول يدع كل شيء حيث تركه القدماء لا يناله بتغيير ولا تبديل، ولا يمسه، في جملته وتفصيله إلا مساً رقيقاً، أما المذهب الثاني قيقلب العلم القديم رأساً على عقب، وأخشى إن لم يمح أكثره أن يمحي منه شيئاً كثيراً)صفحة 62، ويتابع الدكتور قائلاً: (والنتائج اللازمة لهذا المذهب الذي يذهبه المجددون عظيمة جليلة الخطر، فهي إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى أي شيء أخر، وحسبك أنهم يشكون فيما كانوا الناس يرونه يقيناً، وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه، وليس حظ هذا المذهب منتهياً عند هذا الحد، بل هو يجاوزه إلى حدود أخرى أبعد منه وأعظم أثراً، فهم قد ينتهون إلى تغير التاريخ، أو ما اتفق الناس على أنه التاريخ، وهم قد ينتهون إلى الشك في أشياء لم يكن يباح الشك فيها، وهم بين اثنين، إما أن يجحدوا أنفسهم ويجحدوا العلم وحقوقه، فيريحوا ويستريحوا، وأما أن يعرفوا لأنفسهم حقاً، ويؤدوا للعلم واجبه، فيتعرضون لما ينبغي أن يتعرض له العلماء من الأذى ويحتمل، ما ينبغي ما يحتمله العلماء من سخط الساخطين) صفحة 65.
قراءة بسيطة في مضمر قول الدكتور وما بين سطوره /النص الغائب/ تشير إلى المرامي، البعيدة للكاتب، والمضمرة من قبله، فهو يعتقد أن التاريخ لا يكتب مرة واحدة ويقرأ أكثر من قراءة، ويفسر ويؤل أكثر من تأويل، وثمة حقائق يجب إعادة النظر فيها، وهذا ما أدركه الخصوم، من الظلاميين، والمحافظين، ومدعي التقدم، ولذلك انهالت الردود على طه حسين، والتي بلغ عديدها آلاف الصفحات، استشعر الخصوم خطوة ما يفعله، لا بالاستنتاجات لتي توصل إليها، ولا بالمعلومات التي قدمها، والأفكار التي ناقشها، فهي قابلة للمحاججة والنفي والإثبات، وإنما الخطوة في المنهج الذي اتبعه، والطريق التي تناول بها مادته، والمرجعيات التي استند إليها، أحس الخصوم الخطر الكامن في عمل طه حسين، وجوهره، إعادة النظر في المنقول، والارتقاء به إلى المعقول، وهي المشكلة الأهم في تاريخ الثقافة العربية،/النقل والعقل/.
لم يكن طه حسين متنوراً فقط وإنما كان ثورياً وحتى ولو غضب من يعتقدون أن الثوري من يمتلك نظرية ثورية، ومنهجاً ثورياً، ألم يكن منهج الدكتور ثورياً، لقد قلب ما كان يعتقد بأنه حقائق لا يمكن المساس بها، لقد وضع المقدس في امتحان أمام الواقع، وتصدى لأهم مشكلة في تاريخنا، وهي تاريخية الظواهر،/تأريض السماوي/، وإخضاعه لقوانين التاريخ ومتغيرات الواقع.
طه حسين مثقف رسولي حمل عبء الكلمة ومسؤولية الثقافة، ونادى بحق المواطن في العلم والمعرفة، العلم كالماء والهواء، وسار في طريق الآلام فلو أن كل مثقف حمل صليبه كما حمله طه حسين لكان طريق الآلام أقصر بكثير مما هو عليه الآن.
يقدم الدكتور نتائج منهجه (فأول شيء أفجؤك به في هذا الحديث، هو أنني، شككت في قيمة الأدب الجاهلي، وألححت في الشك، او قل ألح عليّ الشك، فأخذت أبحث وأفكر وأقرأ واتدبر، حتى انتهى بي هذا كله، إلى شيء الا يكن يقيناً فهو أقرب إلى اليقين، ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسميه، أدباً جاهلياً ليس من الجاهلية في شيء وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم، وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين، ولا أكاد أشك في أن ما بقي من الأدب الجاهلي الصحيح قليل جداً لا يمثل شيئاً ولا يدل على شيء ولا ينبغي الاعتماد عليه، في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي…وإنما هو نحل الرواة أو اختراق الإعراب أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المحدثين والمتكلمين) صفحة 65.
-2- منهج البحث
يقول الدكتور موضحاً المنهج الذي سلكه في بحثه والذي اتبعه في قراءة التجربة العربية تاريخاً وأدباً:(أريد أن اصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه “ديكارت” للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث والناس جميعاً يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلواً تاماً، والناس جميعاً يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر، قد كان من أخصب المناهج وأقواها وأحسنها أثراً، وأنه قد جدد العلم والفلسفة تجديداً، وأنه غير مذاهب الأدباء في أدبهم والفنانين في فنونهم وأنه هو الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث… نعم ! يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتها وأن ننسى عواطفنا الدينية وكل ما يتصل بها، وأن ننسى ما يضاد هذه العواطف القومية ودينية، يجب أن لا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح…كان القدماء مسلمين مخلصين في حب الإسلام، فأخضعوا كل شيء لهذا الإسلام وحبهم إياه، ولم يعرضوا لمبحث علمي، ولا لفصل من فصول الأدب، أو لون من ألوان الفن، إلا من حيث أنه، يؤيد الإسلام ويعزه، ويعلي كلمته، فما لائم مذهبهم هذا أخذوه، وما نافره أنصرفوا عنه انصرافاً صفحة 68.
يؤكد الدكتور أن هذا المنهج لا يتعلق بالأدب وحده وإنما هو خصب في الأخلاق والحياة الاجتماعية، وهو لا يخص الذين يدرسون العلم ويكتبون فيه بل هو حتم على الذين يقرأون أيضاً.
-3- قراءة الحياة الجاهلية
يجب أن تلتمس في القرآن لا في الأدب الجاهلي
لا ينكر طه حسين الحياة الجاهلية، وإنما ينكر أن يمثلها الأدب الذي يسمونه الأدب الجاهلي، فهو إن أراد أن يدرس الحياة الجاهلية عليه أن يذهب إلى نص لا سبيل إلى الشك في صحته، ويقصد القرآن( فالقرآن اصدق مرآة للعصر الجاهلي، ونص القرآن ثابت لا سبيل إلى الشك فيه)صفحة 70 ، والاستنتاج الأهم في هذا الموضوع هو: (والقرآن لا يمثل الأمة العربية متدينة مستنيرة فحسب فهو يعطينا منها صورة أخرى، يدهش لها، الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الجاهلي في درس الحياة العربية قبل الإسلام، فهم يعتقدون، أن العرب كانوا قبل الإسلام، أمة معتزلة، تعيش في صحرائها لا تعرف العالم الخارجي ولا يعرفها العالم الخارجي، وهم يبنون على هذا قضايا ونظريات، فهم يقولون أن الشعر الجاهلي، لم يتأثر بهذه المؤثرات الخارجية التي أثرت في الشعر الإسلامي، لم يتأثر بحضارة الفرس والروم، وأن له ذلك! لقد كان يقال في صحراء لا صلة بينها وبين الأمم المتحضرة) صفحة 74.
تأمل هذا المقطع يقتح الباب واسعاً لأبحاث ودراسات جديدة تعيد النظر فيما استقر عليه معظم الباحثين حول عزلة العرب وحول نقاء تجربتهم الشعرية وعدم اتصالهم بغيرهم، واطلاعهم على تجارب من سبقوهم وعاصروهم من شعوب المنطقة وغيرها، ونحن نعلم أن ما يسمى بالمنطقة العربية اليوم، غني بالخبرات والتجارب، يشكل في نسيجه العام وحدة حضارية، ولعلنا نجد أيضاً في هذا النص رداً على دعاة الإنغلاق وعدم الانفتاح على العالم المعاصر وتجارب الشعوب، بحجة، أن أجدادنا أنتجوا شعراً خالداً دون الانتفاع، من تجارب الآخرين، وهذا مناقض للعلم ومجاف للمعرفة فنموذج القصيدة الجاهلية، شكلاً وبنيةً، لا يعقل أن يكون ابن مرحلة ما قبل الإسلام بـ 100 – 150 عام كما ذهب الجاحظ، وهو إنتاج عربي صرف، بل هو ثمرة اتصال وتواصل عريقين واطلاع وتمثل لثقافات المنطقة وتجاربها الفنية، في وحدة اتصالها مع العالم الخارجي.
على هذا الأساس يجب أن يدرس بوصفه تلاقحاً ثقافياً وتخصيباً إبداعياً، فما هو صحيح اليوم /القانون العام/ هو صحيح في الماضي، الإنغلاق لا يثمر، وهو شكل من أشكال الموات، وفي الانفتاح وتثمير وتوطين تجارب الآخرين حياة واستمرار.
-4- الأدب الجاهلي واللغة
يخلص طه حسين إلى نتيجة مفادها، إن الشعر الجاهلي بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية، في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه، وهو يميز بين العرب العاربة ولغتها لغة حمير، وبين لغة عدنان وهي العرب المستعربة، وقد روي عن عمرو بن العلاء أنه يقول: (ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا) صفحة 81، ثم يسهب بتبيان الفروق بين اللغتين، والفرق بين لغة الشمال ولغة الجنوب ولأي منهما السيادة، وهل السيادة قبل الإسلام، أو بعده؟
ويؤكد مستنداً على التاريخ أن السيادة السياسية قبل الإسلام كانت للجنوب فلماذا لم تسد لغته؟
أما السيادة للشمال فكانت بعد الإسلام، فسيادة لغته مفهوم، ولكن كيف نفهم سيادة لغة الشمال على أهل الجنوب قبل الإسلام، كيف تكلم امرؤ القيس بلغة الشمال وهو جنوبي، ويسهب طه حسين في تأكيد وتأييد أفكاره بأمثلة عديدة مع شواهد نصية، تبين الفرق بين اللغتين، لينتقل بعدها إلى دليل آخر.
-5- الشعر الجاهلي واللهجات
يثير طه حسين مسألة على درجة كبيرة من الحساسية والأهمية، وهي خلافية حتى في المرحلة الإسلامية وهي موضوع القراءات، (أنزل القرآن على سبعة أحرف) وهو حديث للرسول، ويرى طه حسين، أن القراءات السبع ليست من الوحي في كثير أو قليل، وليس منكرها كافراً ولا فاسقاً ولا مغتمزاً في دينه، وإنما مصدرها اللهجات واختلافها، ويخلص إلى أن (حتى أنك لتحس كأن هذا الشعر الجاهلي إنما قد على قد القرآن والحديث، كما يقد الثوب على لابسه، لا يزيد ولا ينقص، عما أراد طولاً وسعةً)، وذلك لأسباب لها علاقة بالأدب وعلم الكلام والخلافات المذهبية وأغراض التعليم. صفحة 108.

الكتاب الثالث
أسباب نحل الشعر
1_ ليس النحل مقصوراً على العرب
ينطلق طه حسين من أن الباحث يجب أن يعود إلى درس تاريخ الأمم القديمة، ومقارنته مع تاريخ العرب، ليجد أن النحل ليس خاصاً بالعرب وحدهم وهو موجود عند الأمم التي تقارب تجربتها، التجربة العربية، وخاصة الأمم التي تحضرت بعد بداوة وغادرت حدودها الأصلية كاليونان الذين تركوا فلسفةً وأدباً والرومان الذين تركوا تشريعاً ونظاماً.
2- السياسة ونحل الشعر
بعد عرض لأهم المفاصل التاريخية للإسلام والنعرات والخلافات التي صاحبت لقبائل وصراعها يصل إلى خلاصة: (إذا كان هذا تأثير العصبية، في الحياة السياسية، وقد رأيت طرفاً يسيراً من تأثيرها في الشعر والشعراء، فأنت تستطيع أن تتصور هذه القبائل العربية في هذا الجهاد السياسي، العنيف، تحرص كل واحدة منها على أن يكون قديمها في الجاهلية خير قديم، وعلى أن يكون مجدها في الجاهلية رفيعاً موغلاً بعيد العهد، وقد أرادت الظروف أن يضيع الشعر الجاهلي، لأن العرب لم تكن تكتب شعرها بعد وإنما كانت ترويه حفظاً، فلما كان ما كان من الإسلام، من حروب الردة، ثم الفتوح، ثم الفتن، قتل من قتل من الرواة، والحفاظ خلق كثير، ثم أطمأنت العرب في الأنصار أيام بني أمية، وراجعت شعرها فإذا قد ضاع أكثره، وإذا أقله قد بقي، وهي بعده في حاجة إلى الشعر تقدمه وقوداً لهذه العصبية المضطرمة، فاستكثرت من الشعر وقالت منه القصائد الطوال، وغير الطوال، ونحلتها شعراءها القدماء صفحة 130، وينتهي الدكتور إلى حكم 🙁 ومهما يكن من شيء فإن هذا الفصل الطويل ينتهي بنا إلى نتيجة نعتقد أنها لا تقبل الشك، وهي أن العصبية وما يتصل بها من المنافع السياسية، قد كانت من أهم الأسباب لتي حملت العرب على نحل الشعر الجاهليين، وقد رأيت أن القدماء قد سبقونا إلى هذه لنتيجة صفحة 132.
وليأذن لنا الدكتور طه حسين بمداعبة بسيطة بأن نتيجته التي لا تقبل الشك تتعارض مع منهجه في الشك، فمن أباح له الشك، في استنتاجات الآخرين قد يجيز لنا الشك في استنتاجاته، هذا أولاً، وثانياً إذا ثبت تاريخياً أن الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام كان مكتوباً وأن العرب أمة قارئة كاتبة أفلا يضرب هذا أحد أهم مستندات الدكتور حول الرواية الشفوية للشعر العربي في العصر الجاهلي.
-3- الدين ونحل الشعر
يبين طه حسين اثر الدين، وما يترتب عليه، من خلافات بين المسلمين والمشركين حول إثبات صحة النبوة، وصدق النبي، وما روي ممهداً للدعوة لنبوية ثم لاحقاً، لتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش وبعدها تأكيد معاني وألفاظ القرآن، وأنه مطابق لألفاظ العرب ومعانيهم، ثم تأثير شعراء النصرانية، واليهودية، الذين (تعصبوا لأسلافهم من الجاهليين، وأبوا إلا أن يكون لهم شعر كشعر غيرهم من الوثنيين، وأبوا إلا أن يكون لهم مجد وسؤدد، كما كان لغيرهم مجد وسؤدد أيضاً، فنحلوا كما نحل غيرهم، ونظموا شعراً أضافوه إلى السموءل، وإلى عدي بن زيد، وغيرها من شعراء النصارى) صفحة 146.
-4- القصص ونحل الشعر
مختصر حديث طه حسين حول دور القصص في نحل الشعر (الحق أن الأدب العربي لم يدرس في العصور الإسلامية الأولى لنفسه، وإنما درس من حيث هو وسيلة إلى تفسير القرآن وتأويله، واستنباط الأحكام منه ومن الحديث، وكان هذا كله أدنى إلى الجد، وألصق به من هذا القصص الذي كان يمضي مع الخيال، إذا أراد، ويقترب من نفس الشعب، ويمثل له أهواءه وشهواته ومثله العليا، فليس غريباً أن ينصرف عن القصص أصحاب الجد من المسلمين صفحة 149)، فكل ما قيل حول توضيح اسم من الأسماء أو شرح لمثل وكل ما يروى عن عاد وثمود وجديس وطسم وجرهم والعماليق موضوع لا أصل له، وكذلك كل ما يروى عن علاقات العرب قبل الإسلام بالأمم الأخرى كالفرس واليهود والأحباش خليق أن يكون موضوعاً.
ثم يستعرض طه حسين دور الحركة الشعوبية في نحل الشعر، ثم يفرد مقطعاً للرواة ونحل الشعر، ليختتم كتابه الثالث أسباب نحل الشعر بالخلاصة التالية:(كل شيء في حياة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى كان يدعو إلى نحل الشعر وتلفيقه، سواء في ذلك الحياة الصالحة، حياة الأتقياء والبررة، والحياة السيئة، حياة الفسق وأصحاب المجون صفحة 173).
الكتاب الرابع
-1- الشعر والشعراء
أهم ما جاء في هذا الكتاب الحديث عن القدماء والمحدثين، وهي مسالة قديمة جديدة، المهم فيها، انتصار طه حسين للمحدثين، والتصدي للقدماء: ( ليس لهذه التفرقة مصدر إلا هذه الفكرة التي تسيطر على نفوس العامة في جميع الأمم وفي جميع العصور، وهي أن القدامة خير من الجديد، وأن الزمان صائر إلى الشر لا إلى الخير، وأن الدهر يسير بالناس القهقرى، يرجع بهم إلى وراء، ولا يمضي بهم إلى الأمام صفحة 178)، ويفسر ذلك بأن الانحياز إلى القديم لأنه قديم لا نراه، من جهة ولأننا ساخطون بطبعنا على الحاضر من جهة أخرى، ويرى أن القدماء شراً من المحدثين، كما لا نعتقد أنهم كانوا خيراً منهم، وإنما هم سواء لا يفرق بينهم، إلا ظروف الحياة لتي تصور طبائعهم صوراً ملائمة، فالقدماء كانوا يكذبون، كما يكذب المحدثون، وكان القدماء يخطئون كما يخطئ المحدثون، وكان حظ القدماء من الخطأ أعظم من حظ المحدثين، لأن العقل لم يبلغ من الرقي في تلك العصور ما بلغ في هذا العصر، ثم يتحدث عن شعراء اليمن فيقول: (لم يكن لليمن في الجاهلية إذاً شعراء، وما كان ينبغي أن يكون لها شعراء، لأنها لم تكن تتكلم العربية، ولا تلم بها، إلماماً يكفي لأن تتخذها لغة الشعر صفحة 184)، ينتقل الكاتب بعدها إلى امرؤ القيس وعبيد وعلقمة، ويقول حول امرؤ القيس : أن هناك أكثر من امرؤ القيس، اختلفت شخصياتهم، ولكنها جمعت في المخيال الشعبي بشخص واحد، وبنفس الطريقة يناقش أشعار كل من عمر بن قميئة، والمهلهل، وجليلة، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة، ويتوقف عند قصة طرفة بن العبد، والمتلمس، فالأعشى.
الكتاب الخامس
شعر مضر
-1- الشعر المضري والنحل
لقد نحلت مضر وتكلفت كما نحلت اليمانية وتكلفت، كما نحلت ربيعة وتكلفت.. لقد كانت قريش أكثر القبائل المضرية تكلفاً للشعر. ويتساءل المؤلف كيف نشأ الشعر المضري، ما أصل أوزانه، بعبارة أدق كيف نشأت القصيدة؟ ويقدم وجهة نظر جديرة بالاهتمام والمتابعة قائلاً: (نحن لا نستطيع أن نقبل الشعر العربي، قد نزل من السماء، أو نشأ كاملاً، وإنما نشأ ضعيفاً، واهناً، مضطرباً، ثم قويَ، ونما واتسقت أجزاؤه شيئاً فشيئاً حتى بلغ أشده، قبل العصر الذي ظهر فيه الإسلام، وذهبت عنا طفولة هذا الشعر، وذهبت عنا مظاهر تطوره أيضاً صفحة 249).
لعل هذه الفكرة من ألمع الأفكار التي قدمت حتى الآن حول نشأة الشعر الجاهلي، فهي تنسف كل ما هو متعارف عليه، من تفكير متعال على الوقائع، ويقول بالكمال، وهو عند القدماء طبعاً، فكرة الدكتور طه حسين تأخذ بمفهوم التدرج بالنشأة وبالتطور والارتقاء من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً ومن الأدنى إلى الأعلى، وبذلك يضع حداً للفهم المثالي وينتصر للتفكير العلمي والعقلانية في البحث.
ثم يقدم أشكالاً وطرائق جديدة، للتميز بين الموضوع من الشعر /المنحول/ من الصحيح ويقترح معيار النقد الداخلي ثم غرابة اللفظ، وبداوة المعنى، المقياس المركب، ثم يكشف عن مدرسة شعرية يسميها المدرسة الأوسية، تبدأ من أوس بن حجر، وتتواصل إلى العصر العباسي، وهي مدرسة حسية شديدة العلاقة مع الواقع أبرز ممثليها، أوس، زهير، النابغة الذبياني، كعب بن زهير، الحطيئة الخ..
خلاصة ونتيجة:
قد لا نتفق مع كل ما قاله طه حسين، أخاذين بعين الاعتبار ما توصل إليه العلم الحديث، فنحن لا ننسى المدة الزمنية التي تفصلنا عن الكاتب وعن ظروف صدوره، والمستوى المعرفي وما أنجز في مجالات العلوم المختلفة، حيث يؤسس لحوارية المعارف واتصالها وسرعة انتقالها.
مأثرة طه حسين انه قال آراءه وطرح أفكاره بشجاعة وجرأة، بغض النظر عن الأفكار ذاتها، فدفع ما هو معروف من ثمن، لم يقتصر على الاحتجاج والصراخ وإنما ألصقت به تهم الكفر والزندقة، وذهبوا إلى المطالبة بقتله.
أهمية كتاب في الأدب الجاهلي في منهجه، وفي طريقة التناول، وفي الأسئلة، والقضايا التي أثارها، وليس في ما قدمه عليها من أجوبة، أهميته في إغواء السؤال وتحفيز الأذهان، ومواجهة المحرمات، أما الأجوبة فتذهب إلى الجحيم، والأسئلة واحدها خالدة.
كل فترة زمنية تقدم أجوبتها، تتعدد الأجوبة وتختلف باختلاف الأنساق المعرفية والذهنيات والمرجعيات التي تتقدم بفعل المنجز العلمي العام… الانتقال من حالة الثبات وهز اليقين وزعزعة المستقر، وتفكيك بناه، هذا بعض ما حاوله طه حسين، فإن قصر في بعض الأجوبة أو أخذه الانفعال في بعضه الآخر، فله عذره، حسبه أنه من أوائل من حاولوا تطبيقياً ونظرياً فك الاشتباك والتعالق، بين التاريخ والأدب والثقافة واللغة من جهة، وبين المقدس من جهة أخرى. وهو الذي يقول في كتابه الأدب الجاهلي: (اللغة ليست علماً من علوم الوسائل تدرس لفهم القرآن والحديث فقط، وإنما هي علم يدرس لنفسه، ويقصد به قبل كل شيء إلى تذوق الجمال الفني فيما يؤثر من كلام الأدب… اللغة العربية في حاجة إلى أن تتحلل من التقديس، وهي بحاجة لأن تخضع لعمل الباحثين، كما تخضع المادة لتجارب العلماء صفحة 56 -58)، وهذا أخطر ما قاله طه حسين ومن الطبيعي أن يثير المتزمتين والظلاميين، الذين أدركوا مرامي آرائه، لذلك هبوا بكل ما يملكون من قوة إلى مواجهته، بينما لم يدرك أنصار العلم والعقلانية أهمية الرجل إلا في وقت متأخر، فقد ودعهم بقليل من الأمل وبكثير من الألم، لكنه مع هذا كان على ثقة تامة بأنهم سيدركون في يوم ما أهميته، وأنه معهم في خندق واحد ضد القوى الظلامية، وضد التجهيل، ومع الانفتاح، حيث قال في محاضرة له أثناء احتفالية به في الأرغواي: (ونحن في نهضتنا الحديثة النامية وفي تطلعنا إلى الغد المشرق، نعمل ما وسعنا، للعمل على أن نعزز صلاتنا بالفكر الإنساني على تعدد آفاقه ونحاول ما وسعنا، المحاولة أن نقاوم العزلة بجميع ألوانها، ولنا من ثرائنا التاريخي وطابعنا العقلي وقيمنا الفكرية ما يحفزنا إلى ذلك من إيمان وعزم وإصرار).
فهل أخطأ من قال عن عميد الأدب العربي طه حسين: (لقد كان مبصراً في ليله أكثر منا في نهارنا).
الدكتور عاطف عطا الله البطرس
[1] ) المقبوسات من كتاب في الشعر الجاهلي الصادر عام 1926 عن دار الكتب المصرية
[2] النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث لمؤلفه الدكتور غالي شكري دار الطليعة بيروت الطبعة الأولى 1978